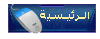بالأمس التقيت صديقاً من إحدى المحافظات الشمالية، لم أره منذ سنوات، في الحي الجديد من العاصمة، وكنت خارجاً من إحدى الأمسيات الأدبية التي لم يزد الحاضرون فيها على ثلاثين شخصاً. فدعوته متحمساً بعد السلام، إن كان لديه بعض الوقت، إلى فنجان قهوة في مكان قريب. أسعدني قبوله، إذ ستكون فرصة نتبادل فيها بعض الحديث الذي انقطع فترة بيننا. ولم أكن قد دخلت هذا المكان الأنيق الواسع الملحق بالفندق، والذي جعل بترتيبه وكراسيه و«أراكيله» مقهى ومطعماً «شعبياً». لذا فوجئت، قبل أن يستقر بنا المقام، بنادل يبادرنا بعلبة صغيرة من المناديل التي أغرقت السوق بعشرات وعشرات من الأسماء، وبزجاجة ماء «بقين» مبردة، لم نطلبها، ولن نكون في حاجة إليهما في جلستنا القصيرة. ثم حضرت القهوة فعطرت حديثنا الذي سرعان ما استعاد ألفته وكأننا لم نفترق. وأخبرني أنه جاء يلاحق موضوع استقالته من العمل بعد خدمة ثلاثين سنة، وأن رجليه «تكسرتا» وقدميه تورّمتا من كثرة المشي من هنا إلى هناك، وصعود الدرج مرات ومرات في الدائرة الواحدة، وهو في سبيل البحث عن عمل في إحدى المصالح الخاصة لأن مرتبه، بعد هذه الخدمة، لن يزيد على ثلاثة آلاف ليرة، وفي أحسن الأحوال أربعة آلاف، وكيف يستطيع مع هذا الغلاء أن «يدبّر» الأمر وقد كبر الأولاد وزاد مصروفهم..
وإذ كان على موعد قريب هذا المساء، فقد سارعت بطلب الحساب، وأنا أتحسس للاطمئنان في جيبي ثلاث مئة ليرة لا أملك سواها، وأحاول، دون قلق، أن أحدس المبلغ المطلوب. وبعد أن طال انتظارنا حضر كبير الخدم في المقهى، ببزته السوداء الأنيقة، وعلى ذراعه «بشكير» لم أدر ما فائدته، وفي يده صحن خزفي فاخر فيه شيء كألبوم الصور، وضعه أمامي، وتراجع خطوتين أو ثلاثاً. وسحبت الورقة البيضاء التي كانت تطل من الألبوم المزخرف، وقد بدأ قلبي يرتجف، بعد هذه المظاهر، توقعا لرقم يفوق حسابي، وفعلاً ما إن قرأت المبلغ المطلوب حتى فرّ الدم من عروقي. فقط مئتان وخمسون ليرة لا غير، ومع ذلك تماسكت. وتم بعد ذلك كل شيء بسرعة. وضعت المبلغ الذي كان معي كله في الصحن، فتقدم كبير الخدم بخطوات منتظمة وثابتة، وتناول الصحن ومضى. وغاب دقائق ثم عاد بالصحن نفسه وبالألبوم نفسه تطل منه ورقتان من فئة الخمس والعشرين ليرة. وتحت نظرات صديقي الذي أصابه الحرج، ونظرات نادلين لا أدري من أين انبثقا فجأة، تركت قطعة واحدة في الألبوم، وسحبت واحدة أودعتها، بأمان، في جيبي، وخرجنا.
وبعد أن ودّعت صديقي، أخذت أتمشى قليلاً قبل أن أستقل «الميكرو باص»، لأجري بعض العمليات الحسابية، وكم كانت دهشتي عظيمة حين وصلت إلى نتيجة بسيطة وهي أن أمثالي من الموظفين الحاصلين على إجازة من الجامعة يستطيعون بمرتبهم الشهري كله، أن يشربوا أربعين فنجاناً من القهوة لا غير في مثل هذا المقهى «الشعبي» أي بمعدل فنجان وثلث في اليوم الواحد مع المناديل الورقية وماء «بقين» ودون «بخشيش». ويستطيع صديقي بمرتبه التقاعدي أن يشرب فنجاناً واحداً لا غير.
وبعملية تداع حر قمت بحساب مماثل لفناجين القهوة لموظف من أمثالنا في بلد متقدم، وفي مقهى متقدم أيضاً وليس شعبياً كهذا، فكان في حدود ثماني مئة فنجان بالتمام والكمال أي عشرين ضعفاً، فأصابني مس من اكتئاب خانق، وأنا أتذكر المطاعم الفاخرة، والفنادق الممتازة الغاصّة بالرواد في كل الأوقات، والإكراميات التي ترش، بعشرات الأوراق النقدية من فئة خمس مئة ليرة، فوق رؤوس راقصات أو مطربات من الدرجة العاشرة.
ولكن اكتئابي بدأ يتلاشى، وأنا أحمد الله على ضيق وقت صديقي، فلم أكن مضطراً إلى دعوته إلى العشاء. وتلاشى اكتئابي تماماً حين استقبلتني زوجتي «بغلاية» كاملة من القهوة، شربتها كلها نكاية بالمقهى «الشعبي» فأطارت النوم من عينيّ!