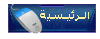لم نكن ندري، حين كنا صغاراً، أو لم نسأل أنفسنا: لم حملت مقبرة الأربعين هذا الاسم؟ وعرفنا، حين كبرنا، أن أربعين شهيداً يرقدون فيها رقدتهم الأخيرة.
لقد احتلت المقبرة حيزاً كبيراً من عالما الطفولي. كانت مرتعنا في النهار؛ نمارس بين قبورها كل ما يخطر على بال الأطفال: نلعب «بالدحاحل» الصغيرة، وكانت تسحرنا ألوانها الخلابة، وفنون ألعابها. نلعب لعبة المربعات، وكنا نسميّها «الحجلة». نلعب «طوح شبار». نلعب «الزقطة» بمكعبات الحصى. نلعب «عسكر وحرامية». نلعب «حَضَر» . نلعب الغميضة. نلعب جمال ياجمال. نلعب طاق...طاق ...طاقية. ونتخذ من القبور، أحياناً، أحصنة، تحملنا إلى آفاق بعيدة. كنا نجري، نقفز، نتدحرج، نتسابق، نتصارع، نحفر أوكاراً وقنوات، نقيم مباريات كرة قدم. لا يصدّنا عن ذلك برد الشتاء ولا مطره، ولا وهج الصيف ولا غباره. ولكل فصل ألعابه المفضلة.
وكنا لا نكاد نذكر علاقة القبور بالموت، حتى يُحمل إليها نازل جديد. فنشارك، بحماسة، في طقوس الدفن. ننضم إلى الموكب المهيب. نحمل حزم الآس الخضر الطويلة. نرحل مع المؤذن الذي يقود الموكب بصوته الحنون، إلى عالم غريب. نتنشق رائحة عطر غريب حاد مُسكر. نرى حين نصل إلى المقبرة، بقلوب واجفة، الكفن الأبيض اللامع الذي يُلفّ به الميت، ينقل من التابوت الخشبي إلى القبر وسط أصوات التهليل والتكبير. نشارك في إحضار الحجارة لسدّ الثغرات التي تتركها الصخرة البيضاوية من جوانب القبر، وفي نقل الطين وإهالة التراب. وأخيراً نجلس خاشعين مع الجالسين، على عتبة عالم مجهول، نصغي إلى الشيخ يلقن الميت ما يجب ألا ينساه إذا زاره الملكان أنكر ونكير بعد انفضاض الناس.
ولكن المقبرة، ومن عجب، قد حفرت في أعماقي دروباً من الهول والرعب حين كان يجن الليل. فإذا اضطررتُ، وقلّما أُضطر، إلى المرور من طريقها ليلاً، فقد كنت أجري كالريح، قبل الوصول إليها، لا ألوي على شيء، لا ألتفت ناحية القبور، ولا ألتقط أنفاسي حتى أكون قد دخلت في الزقاق الجانبي، وغابت القبور عني. كانت تستيقظ في كياني كل الحكايات عن عالم الجن والعفاريت والأشباح، وتصحو لديّ كل هاتيك القصص التي سمعتها عن الأموات الذين ماتوا ظلماً، يقومون ليلاً بين القبور، يحدثون عن الظلم الذي لحق بهم، وعن الأولياء الصالحين، طوال القامة دائماً، مكتنزي الجسم، يرتدون الأبيض من قمة الرأس إلى القدمين، يخرجون من القبور، يطوفون بينها، يسبحون بحمد الله، ثم يعودون آخر الليل إلى قبورهم الكبيرة المتميزة، التي أحيطت بجدران طينية ذات نوافذ حديدية خضر ، يرتعش فيها دائماً نور شموع، لا يدري أحد متى وضعت، ومتى أضيئت.
كنّا قد انتقلنا إلى حيٍّ جديد مجاور حين توفي والدي. لأول مرة أعاني الموت والفقد حقاً لإنسان، كل ما فيّ مرتبط به: القرية البعيدة.. الطفولة.. الحب.. الحنان.. النجاح.. كل شيء فيه غدا جزءاً منا ومن حياتنا اليومية.. الغرفة التي كانت تضمنا معه.. رائحته.. تنفسه.. تبغه.. سعاله.. كان من الصعب التخلي عن أي شيء منه. كان فقده مفاجئاً.. ضربة قاصمة.. موجهة لي بالذات.. لا أدري لم.. ربما لأنه كان يحبني أكثر من نفسه.. كنت أشعر أني، بمعنى ما، رأس ماله الوحيد.. ربما لأنه انتظر كل أيام الغربة والفقر والشدة والمرض ، ليأكل من تعبي، بعد أن بذل كل شيء من أجل تعليمي. كان قاب قوسين أو أدنى من قطف ثمرة تضحيته. مات قبل أن أقبض قرشاً من عملي. أية حسرة حملها وحده؟.
لم أستطع أن أبكيه حين مات.. أياماً وأياماًً أحاول أن أقنع نفسي أن أبي قد مات، ومن حقه عليّ أن أبكيه.. لم أستطع.. تحجّر دمع عيني. وحين مرّ على موته بضعة أسابيع.. وحين أيقن كائن في داخلي أنه قد مات حقاً.. عدت إلى بكائه بدموع سخيّة سخينة.
أصبح والدي من نزلاء مقبرة الأربعين بعد أن أوصى أمي أن يدفن في قبر جدّي. وكنت قد دخلت مرحلة من العمر جديدة وغادرت عالم الطفولة. ولكني مع ذلك لم أتعلم المشي في الليل قرب المقبرة دون إحساس الرهبة والتحفز والخوف؛ إذ كانت تستيقظ، في نفسي، الأصداء البعيدة العميقة. وكنت أنحرف عن طريقي إلى الحي الجديد لأسلك الطريق القديم إلى المقبرة، وأعرج باحثاً بين القبور الطينية المتشابهة عن قبر والدي، لأقرأ ذاهلاً الفاتحة على روحه وروح جدّي. كنت في هذه اللحظات أقتحم عالماً مسحوراً غريباً لا أخرج منه حتى أستأنف طريقي، وتأخذني، من جديد، أمور الحياة اليومية المستعجلة دوماً.
غبتُ عن المدينة سنوات ثلاثاً، حملت معي فيها، إلى بلاد البرد والثلج والضباب، مدينتي: شوارعها.. حاراتها القديمة.. روائحها.. همومها.. كل ماحفرته الطفولة على جدران روحي.
وذات يوم عدت إليها، وكان لابد لي أن أعود. وقادني طريقي إلى درب مقبرة الأربعين. قلت في نفسي: لأقرأ الفاتحة على روح والدي وجدي بعد هذا الغياب الطويل. وقفت مصعوقاً خيّل إليّ في بداية الأمر أنني أخطأت الطريق. فقد ارتفع مكان المقبرة ثلاث عمارات هائلة، متماثلة، شاهقة، تناطح السماء، وتجثم ثقيلة ـ كما تخيلتُ ـ على صدور الموتى، وبينهم والدي وجدي والأربعون شهيداً والمظلومون والأولياء الصالحون. ولما صحوت من هول المفاجأة. بسطتُ كفّي، دون أن أدري ما أفعل، وقرأت الفاتحة وانسللت هارباً. كان عالم كامل يتهاوى في داخلي بلا رحمة.
وانقطعت هذه الأيام عن سلوك الطريق القديم إلى المقبرة؛ فمن بعيد أرى سواء أكنت ماشياً أم راكباً، العمارات المتماثلة، الشاهقة، الثقيلة، فأبسط كفيّ، وأقرأ الفاتحة على روح والدي وجدي والأموات جميعاً وعالم طفولتي الذي كان يوما!.