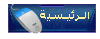الجسد المسجَّى، هناك في غرفة الاستقبال في بيته، جسده هو..، ها هي لحظة الافتراق.. الابتعاد عن كل شيء، عن اللوحة الناقصة، عن التربنتين، عن الألوان والطلاء، تأتي. طالما ردد حينما خطر في باله ما يحصل الآن، أن هذه اللحظة آتية لا ريب فيها، فعلا إنها آتية، بل ها هي تأتي لتفرح القلة، وتحزن الكثرة. ها هو يرى القلة بالضبط مثلما رآها قبل خروجه من جسمه. ها هو يرى زوجته وديعة، وأمها، أم الوديعة، إنهما هما الاثنتان فقط، من يمكن أن يفرحهما رحيله، وديعة لأنها ستقبض مخصصاتها أرملة من مؤسسة التامين الرسمية، وأمها لأنها سترتاح من نق ابنتها، على زوجها، ومن عدم رضاها عن حياتها معه، ومن غرامه لألوانه وطلائه.
الجو حار، والغرفة تضيق برائحة العرق، والضراط، تختلط الدموع بقطرات العرق، فتنتج رائحة كريهة، تدفعه لأن يغادر سريعا، تضع والدة وديعة يدها على أنفها، إلا أنها لا تلبث أن تزيلها. ربما هي خجلت من أن توجه إليها أخريات من الجالسات حول الجسد، نظرات الانتقاد، ربما هي تريد أن تقنع نفسها بأن الرائحة هي رائحة الميت، مهما يكن هي لن تقتنع بعد رحيله، أن الرائحة إنما هي رائحة ضراطها وضراط ابنتها، ومن يعلم، فقد ترفع رأسها شمما واستعلاء، وهي تعرف من هي تمام المعرفة، تعرف أن المغص المزمن حينما ينتابها، لا يغادر إلا حينما تبتعد عن الناس، وتطلق سراحه، فينساب مثل مادة كيماوية، تنساب ناشرة في الأجواء رائحة مقززة، اعتادت عليها، لكثرة ما الفتها، خاصة حينما كانت ابنتها تزورها فتنتابها حالة من المغص تشبه ما انتاب والدتها منها، فتأخذ الاثنتان في التساؤل عن سبب الرائحة، مستبعدتين في كل الأحوال أن تكونا هما مصدرها.
يا لطيف الرائحة ذات الرائحة، إنها ما اعتاد على استنشاقها مرغما حينا وبخاطره حينا آخر، إلا أن جسده المسجى هناك، وفر هذه المرة، لحماته وابنتها، أن تضعا كل يديهما على أنفيهما، ولو في محاولة لإقناع الذات بأن ما صدر من رائحة عطنة طوال مدة نافت على الثلاثة عقود من الزمن، هي مدّة وجوده معهما، إنما كانت رائحته هو ورائحة تربنتينه، وليست رائحة أي شيء آخر. ها هي كل واحدة منهما على حدة، تجد الفرصة للتأكد من أن ما خطر لها حول رائحته المقززة، إنما كان حقيقة وليس خيالا، رغم محاولاته المتواصلة لإثبات براءته من تهمة انبعاث الرائحة الكريهة منه ومن ألوانه ولوحاته.
ينظر إلى الوجوه، إنها وجوه نساء أحببنه، كل منهنَّ أتت، حينما أتت أول مرة، من ناحية، ولسبب يختلف، واحدة أتت لتتعرَّف إليه هو الفنان الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، أخرى وقع في طريقها مصادفة، فأعجبتها رومانسية الفنان الكامنة في كل كلمة قالها. أخرى لم يمنحها الله الجمال، فأحسَّت أنها الوحيدة في العالم التي يمكنها أن تفهم فنَّانا. أخرى فشلت في بناء بيت وأسرة، وفاتها قطار الارتباط، فسعت إليه، أثناء إحدى عمليات هروبه من رائحة وديعة وأمها وهكذا...
يتنقل بين الوجوه المحيطة بجسده، إنه يعرف تمام المعرفة أن اللحظة دنت، وأنه لن يرى هذه الوجوه مرة أخرى، بعد قليل سيأتي الشبان من أبناء حارته، سيأتي من يعرفه ومن لا يعرفه، سيأتي الشبان الملتحون خاصة، سيرفعونه على رؤوس الأكفِّ، وسيمضون به بعيدًا عن بيته، بعيدا عن وديعة وأمها، بعيدا عن اللوحة هناك في الزاوية، وبعيدا عن صاحبات الوجوه، اللواتي أحببنه كلٌّ بطريقتها الخاصة.
سيمضون به، ستأخذه أم اللُهيم، سيغيب في أحضان هند الأحامس، هناك.. هناك بعيدا عن وديعة وأمها، بعيدا عما ترسلانه من رائحة مزعجة..، بعيدا عن ادعائهما أنه هو وتربنتينه، وليس سواهما من يرسل تلك الرائحة، حتى الآن في لحظة موته، سيتجول في حياض غثيم، سيضع رأسه على جلمود صخر، وسوف ينسى كل ما أنتجه من لوحات أثارت انتباه الجميلات الهائمات بالجمال وبأهله.
ماذا يقول؟ جميلات؟ لوحات؟ فن وأهل فن؟ أما مجنون هو!! كيف يغادر تاركا وراءه هذا كله، كيف يترك لوحته في زاوية الغرفة ناقصة؟ ومن يدريه أنها إذا ما اكتملت، حقَّقت له ذاته، وبينتها له على الأقل؟ فعلا هو مجنون، هو لا يرى الجميلات من صاحبات الوجوه المحلّقات حوله، لا يراهن. بل يراهن.. ها هنَّ يرنون إلى جسده المسجَّى، لقد كسرنَ كل ما هو طابو ومحرم، تمرَّدْنَ على قيودهن، على الأهل والحارة والبلد، وانطلقن إليه، إلى فنانهن وحبيبهن، فان كوخ فلسطين، لا يهمهنَّ سوى أن يرينَ فنانهنَّ الملهَم في لحظته الأخيرة.
الوجوه تكبر تصبح فاتنة، بالضبط مثلما أرسلت إليه نظراتها بخفر وحياء ورفضت أن تدخل إليه في مرسمه، مع علمها ويقينها المكتمل بأنها دخلت قبل أن تدخل، ودخلت دون أن تدخل. آه يا صاحبات الوجوه الجميلة.
يتنقل بين الوجوه، وديعة تصرخ رافضة الرحيل، أمها أيضا تصرخ، إنهما تعرفان أن جسده الفاني سيغادر عما قريب، وأن ما أرادتاه تحقق أخيرا. لحظات وينتهي كل شيء. لحظة ويبدأ زمن آخر، بدونه بدون رائحته النتنة. إنه يقرأ في عيونهما ما سبق وقرأه عشرات وربما مئات وآلاف المرات، وهو أ،ه.. إنسان غير مرغوب فيه، إنسان تنبعث منه رائحة التربنتين والطلاء، إنسان يعيش للوحته، وليس لأي هدف آخر.
يتوقف، عند اللوحة المركونة هناك في زاوية الغرفة، وراء النسوة المتحلِّقات حول جسده المسجَّى. اللوحة ما زالت ناقصة، إنه يعرف. يعرف مائة بالمائة وألف بالألف وحتى مليون بالمليون، أنه عما قريب سيضع رأسه على صخرة في حياض غثيم، وسيصبح جزءا من لون، أو من لوحة كانت، بل هي كائنة. أنه يعرف هذا وأكثر، يعرف يعرف يا وديعة، يعرف يعرف يا أم وديعة، يعرف الدموع الكاذبة، بالضبط مثلما يعرف الدموع الصادقة. يعرف العيون التي تحترمه وتقدره، مقابل عيونكما، الناكرة لكل ما هو جميل فيه، له ولفنه الجميل. هذه العيون تستحق أن ينتج لها لوحتها الخاصة بها، أن يكملها، وألا يتركها ناقصة، فقد عرفته، عرفت أعمق أعماقه، وصلت إلى سحر اللون القابع هناك فانبهرت به. من أجل هذه العيون، من أجل هذه الفتنة، ينبغي أن يعود إلى جسده، ينبغي أن يواصل، عارفا مدركا أن الرائحة الكريهة إنما تنبعث منهما هما الاثنتين، وديعة وأمها، ومؤكدا بما لا يتحمل الهزل، أن الرائحة إنما هي رائحة ضراطهما وليست رائحة تربنتينه، ليعد إذا، ليعد وليثبت هذه المرة بالدليل القاطع، أنهما هما مصدر الرائحة، وإنهما هما هما وليس غيرهما.
شعور فائض بالحياة، بحب اللوحة، وبمن أحبَّها من النسوة المتحلقات حول جسده المسجى في غرفة الاستقبال، يدفعه دفعا للتمرد على إغماضة العينين ومغادرة الجسد، وعلى كلِّ ما في الدنيا من قرارات بأنه انتهى وبأنه عما قريب سيتلاشى، مثلما تلاشت أجيال سابقة من الفنانين، فائض من الشعور يدفع به للعودة، لإكمال لوحتة الناقصة.
ها هو يشعر بنفسه، يندفع عائدا إلى جسده، بالضبط مثلما اندفع خارجا منه، ها هو الجسد يتحرك، يفتح عينيه، يمسح على يديه ويشرع في إزالة كفنه عن جسده. حالة من الدهشة تنتاب الجالسات حول جسده، يرسل إليهن ابتسامة يريدها أن تكون مطمئنة، يتوجَّه إلى وديعة يطلب منها شربة ماء، تنهض هذه من مجلسها، تسير باتجاه حنفية الماء في المطبخ، تتبعها أمها، وديعة تطلق سراح ضرطة حاولت إطلاقها بالتقسيط، منذ وضع جسده في وسط غرفة الاستقبال، تتبعها أمها مطلقة ضرطة مدوية هذه المرَّة.